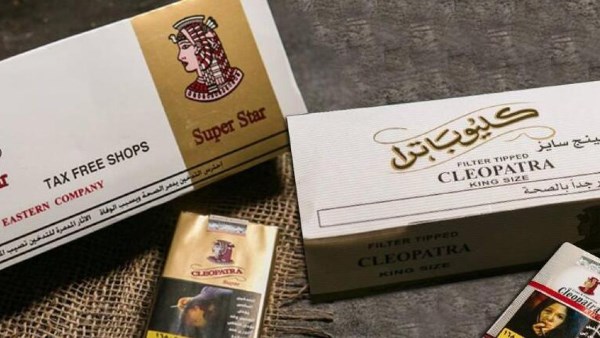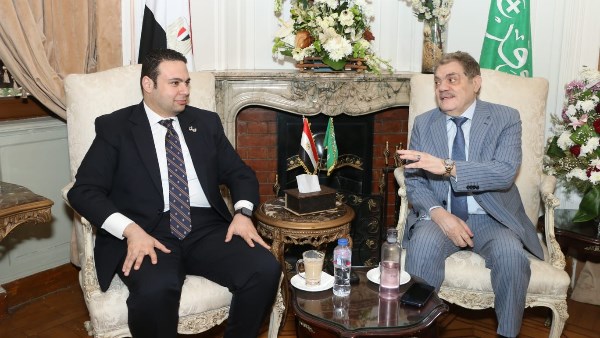حكم التأمين على الحياة في الإسلام؟ هذا ما ورد في الكتاب والسنة

وصل إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يتساءل عن حكم التأمين على الحياة في الإسلام ومدى توافقه مع الشريعة الإسلامية.
حكم التأمين على الحياة
أوضحت دار الإفتاء في ردها على السؤال أن التأمين على الحياة جائز شرعًا، وهو في جوهره يمثل تكافلًا وتعاونًا بين الأفراد لتحقيق الخير والبر، وهو يتفق مع القيم الأخلاقية التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية، التي تدعو للتعاون والتراحم بين المسلمين في حالات المخاطر والتقليل منها.
كما حثَّت الشريعة الإسلامية على التعاون والمواساة، حيث قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» (متفق عليه). وكان شيخ الإسلام الطاهر بن عاشور قد أشار إلى أهمية التعاون في تيسير الأعمال وتحقيق المصالح الاجتماعية.
وقد وضع الإسلام نظامًا اجتماعيًا يساعد في تلبية احتياجات الناس من خلال الزكاة والصدقات التي تعتبر من أبرز صور التكافل الاجتماعي.
التأمين في العصر الحديث
يعد التأمين من أساليب التكافل الحديثة، وهو عقد يلتزم بموجبه المؤمن بدفع مبلغ من المال للمؤمن له أو المستفيدين من العقد في حال حدوث ضرر أو خطر محدد، مقابل دفعة مالية يتم دفعها من الطرف المؤمن. وقد عرفته المادة (747) من القانون المدني المصري لعام 1948.

الأدلة الشرعية على جواز التأمين على الحياة
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، حيث يشمل هذا النص جميع العقود ومنها عقد التأمين على الحياة، وقد أشار العلماء إلى أن الأصل في العقود هو الإباحة ما لم يثبت تحريمه.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ولا يحل لامرئٍ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه» (أخرجه أحمد والدارقطني والبيهقي). وهذا يدل على أن الأموال يجب أن تكون خالية من الضرر والغرر، وهو ما يتوافق مع عقد التأمين الذي يتم برضا الطرفين ودون ضرر أو غرر.
كما أوضحت دار الإفتاء أن العرف يعد من المصادر الشرعية في التشريع، حيث قال الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن» (أخرجه أحمد والطبراني). ولذلك فإن التعامل بالتأمين بناءً على العرف السائد يعد جائزًا في الإسلام.





 جوجل نيوز
جوجل نيوز
 واتس اب
واتس اب