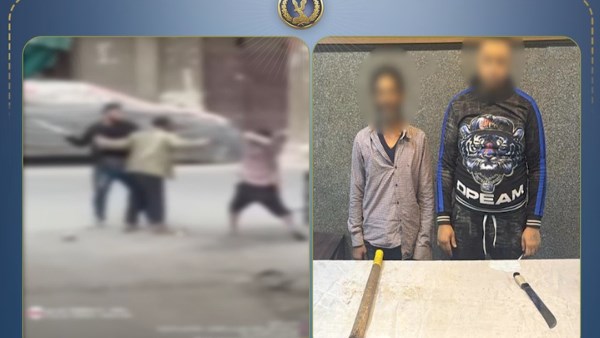مظهر شاهين يكتب: الطاهر بن عاشور… إمام التجديد ومؤسس الفكر المقاصدي المعاصر

في تاريخ الفكر الإسلامي الحديث، قلّما اجتمع في عالِم واحد ما اجتمع في الشيخ الطاهر بن عاشور من عمق الفقه، وبلاغة اللغة، واتساع الأفق، وشجاعة الاجتهاد. لم يكن رجلًا من زمنه فحسب، بل كان صوتًا سابقًا لعصره، يحمل همّ الأمة في عقله وقلبه، ويسعى لإحياء ما اندثر من مقاصد الشريعة، وإعادة وصل ما انقطع بين التراث الأصيل وروح العصر.
لم يكن بن عاشور مجددًا بالمصطلح السهل الشائع، بل كان صاحب مشروع فكري متكامل، استند فيه إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة، وأدوات الاجتهاد الراسخة، ووعيٍ عميق بتغير الزمان وتطور حاجات الإنسان. ترك آثارًا علمية خالدة، لم تضيء فقط طريق الباحثين، بل أثرت في تكوين أجيال كاملة من العلماء والمفكرين، وكان لي شرف أن أكون أحد الذين أفادوا من علمه وأسلوبه، ونهلوا من مدرسته الفكرية خلال رحلتي العلمية.
سيرة عالم من طراز نادر
وُلد الشيخ محمد الطاهر بن عاشور عام 1879 بالعاصمة التونسية، في بيت علم وصلاح، ينحدر من أسرة علمية ذات أصول أندلسية.
نشأ في كنف والده وعمه، وكلاهما من كبار علماء جامع الزيتونة. حفظ القرآن الكريم صغيرًا، وتلقّى علوم اللغة، والتفسير، والفقه، والبلاغة، وأظهر نبوغًا لافتًا أهّله ليكون من ألمع خريجي الزيتونة، ثم من كبار أساتذتها.
تدرج في المناصب حتى تولى رئاسة جامعة الزيتونة، كما لُقّب بـ”شيخ الإسلام” في تونس، وترك بصمات واضحة في تطوير التعليم الديني، ومحاولة تحديث مناهجه دون التفريط في الأصول.
التجديد بالأدوات لا بالشعارات
رأى ابن عاشور أن الأمة لا تنهض إلا بإعمال العقل في ضوء النص، لا بإهمال النص ولا بتقديس الاجتهادات البشرية. فجاء مشروعه التجديدي متكئًا على أدوات راسخة من علم الأصول، والفقه، والبلاغة، ومقاصد الشريعة. لم يكن ثائرًا على التراث، بل ناظرًا فيه بعين الناقد الحريص لا الرافض العابث.
ومن أبرز ما يميز فكره هو إحياؤه العميق لعلم مقاصد الشريعة، ذلك العلم الذي عالجه بإبداع في كتابه الشهير “مقاصد الشريعة الإسلامية”، حيث بيّن فيه أن الشريعة جاءت لرفع الحرج، وتحقيق العدل، وحفظ مصالح الناس في المعاش والمعاد، وأن الاقتصار على ظاهر النصوص دون إدراك مقاصدها يؤدي إلى تعطيل روح الدين وتشويه مقاصده.
بلاغة التفسير وعقل المقصد
من أعظم ما خلّفه الشيخ الطاهر بن عاشور من تراث علمي، تفسيره الموسوعي الفريد “التحرير والتنوير”، وهو عمل ضخم في ثلاثين مجلدًا، جمع فيه بين علوم القرآن والفقه، والنحو والبلاغة، والبيان والمقصد.
وليس هذا التفسير مجرد شرح للآيات، بل هو بناء فكري متكامل، يُقوّم به القارئ فكره، ويهذّب ذائقته، ويُدرّبه على النظر الشامل في النصوص، ما بين اللفظ والدلالة، والمبنى والمعنى، والسياق والمقصد.
وقد كان لهذا التفسير أثر بالغ في حياتي العلمية، وتجربة لا تزال حاضرة في وجداني حتى اليوم. فقد عكفت على دراسته والتعمق في أسراره البلاغية والبيانية خلال إعدادي لرسالة الماجستير التي كانت بعنوان:
“البلاغة القرآنية في تفسير التحرير والتنوير في سورتي آل عمران والنساء – دراسة تحليلية”
والتي نلت بها درجة الماجستير من جامعة الأزهر الشريف عام 2005.
وفي هذا السياق، لا يسعني إلا أن أستحضر بكل وفاء وامتنان اسم العالِم الجليل الذي كان له بالغ الأثر في مسيرتي العلمية، وهو فضيلة الأستاذ الدكتور محمود السيد شيخون رحمه الله، الذي أشرف على هذه الرسالة بعلمه الغزير وخلقه الرفيع.
كان رحمه الله عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية و العربية، ثم نائبًا لرئيس جامعة الأزهر، ويُعد بحق من شيوخ علم البلاغة في عصرنا الحديث، ممن أثروا هذا الفن علمًا وتوجيهًا وتربية، وكان له أثر كبير في تشكيل وعي طلابه، وتعميق ذائقتهم البلاغية، وغرس روح البحث الأصيل في نفوسهم.
وسيبقى اسمه حاضرًا في قلوب من تتلمذوا على يديه، وحق له أن يُفرد له مقال خاص يُنصف سيرته وعطائه، ويُخلّد أثره العلمي والإنساني.
مواقف فكرية وإنسانية
لم يكن الشيخ الطاهر بن عاشور منطويًا في محراب العلم، بل كان واعيًا بقضايا مجتمعه، متفاعلًا مع تحديات عصره. فقد دافع عن كرامة المرأة وحقوقها في إطار الشريعة، محاربًا التقاليد الجائرة التي لبست ثوب الدين.
كما كان من أشد المناهضين للاستعمار الفرنسي، رافضًا محاولات طمس الهوية العربية الإسلامية لتونس، ومدافعًا عن بقاء اللغة العربية والتعليم الديني، دون أن يغفل عن أهمية العلوم الحديثة والتجديد المؤسسي.
إرثٌ لا يزول
توفي الشيخ الطاهر بن عاشور عام 1973، لكن فكره لم يُدفن، بل ظل حيًا في العقول والمنصات والمناهج.
لقد قدّم للعالم الإسلامي نموذجًا نادرًا لعالم يجمع بين التخصص العميق، والرؤية الواسعة، والإيمان بأن الدين جاء لصلاح الدنيا والآخرة معًا.
وفي زمن تتنازعه دعاوى التغريب من جهة، والجمود من جهة أخرى، نحتاج إلى إعادة قراءة مشروع هذا الإمام الجليل، لا كذكرى علمية، بل كدليل عمل.
فلنُعد قراءته، لا كأثر يُحتفى به، بل كمشروع يُقتدى به، يُعيد للعقل المسلم توازنه، ويؤسس لفكر شريف يجمع بين الصدق في الفهم، والجرأة في التجديد، والإخلاص في التبليغ.





 جوجل نيوز
جوجل نيوز
 واتس اب
واتس اب